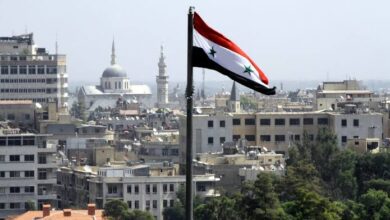انتخابات تونس: الكلمة الفصل للاقتصاد
خمس سنوات في الحكم شهد خلالها العالم أزمات خانقة، تعتبر إنجازا يستحق الإشادة.. هناك وعي تونسي بما يجري في العالم. التونسيون يعلمون أن الاقتصاد وحده هو ما سيحسم نتيجة الانتخابات.

من بين الانتقادات الموجهة من أحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد الانتقادات الاقتصادية، ووحدها يمكن أن تقرر أو تحسم نتيجة الانتخابات.
في ظل ضبابية انتقادات المعارضة وعدم وجود برنامج اقتصادي واضح تتفق عليه تبدو نتائج الانتخابات حتى هذه اللحظة محسومة لصالح الرئيس سعيد.
تتهم المعارضة الرئيس سعيد بالانفراد بالحكم والاستحواذ على جميع السلطات بعد أن قام بحل البرلمان وإقالة الحكومة، وترى في ذلك انقلابا على الديمقراطية، وتنتقد ما تسمّيه قمع الحريات واعتقال شخصيات قيادية “بارزة” وناشطين سياسيين، وتعتبر ذلك قمعا للحريات وتضييقا على حرية التعبير.
وبينما تصر أحزاب معارضة على التركيز على هذا الجانب في الوقت المتبقي للانتخابات، التي حددت يوم 6 أكتوبر القادم، يبدو أن ما يشغل المواطن والشارع التونسي هو أسعار المواد الغذائية والتضخم وخلق فرص عمل، وهي قضايا إن ذكرت في أدبيات المعارضة، تذكر بشكل عارض.
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يصف برنامج المعارضة الاقتصادي، إن وجد، أنه مبهم وغامض. الحديث عن الاقتصاد في أوساط المعارضة اقتصر على تسليط الضوء على الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، ولكن لم يذهب بعيدا في التحليل ليقدم برامج بديلة، وإن قدمها فهي مبهمة غير واضحة.
تلوم المعارضة الرئيس سعيد وتعتبره مسؤولا عن تفاقم الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وشح المواد الأساسية، وتراجع قيمة الدينار.
لن نحتاج إلى التذكير أن الأحزاب، الموجودة في موقع المعارضة اليوم، مسؤولة بشكل أو بآخر عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وإن ما حدث في تونس بداية من عام 2010 هو امتداد لأزمة اقتصادية عالمية بدأت في الولايات المتحدة عام 2008 أدت إلى انهيار العديد من البنوك، وتسببت بأزمة ثقة بالنظام المالي العالمي.
وسرعان ما وصلت أمواج الأزمة إلى السواحل الأوروبية، حيث واجهت البنوك الأوروبية مشاكل كبيرة في السيولة وهو ما استدعى تدخلات حكومية لإنقاذها.
وشارفت دول مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا على الإفلاس، الذي لم تنج منه إلا بمساعدات سخية من الاتحاد الأوروبي.
بالطبع، لم تمرّ الأزمة دون أن تترك مخلفاتها على اقتصادات الدول الآسيوية التي تعتمد على التصدير، نتيجة لانخفاض الطلب العالمي.
الدول النامية دفعت نصيبها هي الأخرى، مع تراجع الاستثمارات تاركة آثارها السلبية على النمو الاقتصادي فيها، وهو ما انجرّ عنه فقدان لفرص العمل وارتفاع في معدلات البطالة.
ما حدث في تونس بعد ذلك يعزى إلى حد كبير لانعكاسات أزمة 2008، التي أدت إلى انخفاض الصادرات بسبب تراجع الطلب العالمي على المنتجات، ولم ينج من ذلك قطاع الخدمات السياحية الوافدة، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في تونس، وشهد تراجعًا كبيرًا نتيجة لانخفاض عدد السياح القادمين من الدول المتأثرة بالأزمة، خاصة الدول الأوروبية.
لم يقتصر الأمر على انخفاض الاستثمارات الأجنبية وضياع فرص العمل. الأزمة رافقتها زيادة في معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
في غمرة الأزمة المستوردة واجهت البلاد صعوبات في سداد الديون الخارجية نتيجة لتراجع الإيرادات وانخفاض الاحتياطيات النقدية، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار التونسي، وزاد من تكلفة الواردات.
وهنا يجب التأكيد على أن انهيار سعر الدينار الذي تحمّل أحزاب المعارضة مسؤوليته للرئيس قيس سعيد، حدث قبل أن يتولى الرئيس صلاحياته. في عام 2019 كان سعر الدولار الأميركي 2.949 دينار تونسي. اليوم سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار 3.13. أي بالكاد حدث تغيير بالسعر.
هل لدى أحزاب المعارضة أيّ فكرة عن المذبحة التي شهدتها أسعار العملة المحلية في دول المنطقة؟ بالتأكيد لا.
وباء كورونا أيضا كان له نصيب في الأزمة التي تشهدها تونس، في 11 مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا الذي ظهر أول مرة في الصين عام 2019 تحول إلى جائحة عالمية.
آثار الجائحة على الاقتصاد التونسي معروفة للجميع. وهذا ملخص بالأرقام لما حدث: انكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 في المئة في عام 2020، وانخفض إجمالي الاستثمار بنسبة 4.9 في المئة، مما أثر على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وتراجع الاستهلاك الأسري والصادرات بنسبة 8 في المئة، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات الوطنية.
وارتفعت معدلات البطالة إلى 21.6 في المئة، مما أضاف حوالي 274 ألف عاطل جديد عن العمل عام 2020 وحده. وزادت معدلات الفقر المالي إلى 19.2 في المئة، مما أثر على مستوى دخل حوالي 475 ألف فرد ووضعهم تحت خط الفقر.
تونس ليست وحدها من تأثر بالوباء، كورونا شلّ اقتصاد العالم وترك ندوبا لم تبرأ حتى يومنا هذا.
لا يمكن الحديث عن الأزمة الاقتصادية دون المرور على ظاهرة الجفاف التي أدت إلى تراجع المحاصيل الزراعية، خاصة الزراعات البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار، وتشكل 92 في المئة من الأراضي الفلاحية.
كما تسببت قلة المياه في انخفاض موارد الأعلاف بنسبة 30 في المئة، مما أثّر سلبًا على الثروة الحيوانية.
القطاع الزراعي ليس القطاع الوحيد الذي تأثّر بالجفاف، الجفاف له تأثير غير مباشر، ولكن مهم، على القطاع السياحي. نقص المياه وانقطاعها في بعض المناطق أثّر على جودة الخدمات السياحية، وعلى توافر وجودة المنتجات الغذائية المحلية التي يعتمد عليها القطاع السياحي.
نختم بإشارة سريعة على الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي أدت إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع في أسعار الطاقة والحبوب، مما أثّر على أمن تونس الغذائي، التي تستورد 80 في المئة من احتياجاتها من الحبوب من هذين البلدين، وهو ما رفع أسعار العديد من المواد الأساسية، ورفع معدلات التضخم.
هذه ليس نهاية القصة، الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، أدخلت البلاد في فوضى سياسية. بين ليلة وضحاها نمت الأحزاب مثل الفطر، ووجدنا أشخاصا ليس لديهم أيّ خبرات أكاديمية ومهنية يعتلون مناصب حساسة بالدولة، من بينها رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
بين عامي 2010 و2019، شهدت تونس 13 حكومة مختلفة. بدأت هذه الفترة بحكومة محمد الغنوشي الأولى في يناير 2011، وانتهت بحكومة يوسف الشاهد.
كل هذه العوامل مجتمعة شكلت مقدمة لما سيحدث لاحقا.
في انتخابات رئاسية، جرت عام 2019، فاجأ المرشح المستقل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، الجميع، بعد أن منحه التونسيون انتصارا باهرا واختاروه في الجولة الأولى من بين 26 مرشحا للرئاسة، وعادوا لتثبيته في الدور الثاني.
حينها فسّر المراقبون هزيمة 25 مرشحا دخلوا السباق الرئاسي إلى جانبه، بينهم رؤساء حكومات ووزراء ورئيس دولة سابق، بردّ فعل التونسيين تجاه أحزاب وحكومات متعاقبة لم تتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم في البلاد.
انتخاب الرئيس سعيد، الذي أمّنه التونسيون على مستقبلهم، لم يحل المشكلة. منصب الرئيس وفق دستور شكلته أحزاب المعارضة ليناسب مقاسها، لم يخول للرئيس كامل الصلاحيات، وهو ما انتهى إلى وضع الحصان خلف العربة.
في يوليو 2021 قرر قيس سعيد تعليق أعمال البرلمان التونسي، وبعد ثمانية أشهر (30 مارس 2022) اتخذ قرارا بحل البرلمان. وفي 25 يوليو 2022، تم تنظيم استفتاء دستوري اعتمدت خلاله مسودة دستور جديدة.
امتلك قيس سعيد الشجاعة ووضع الحصان أمام العربة، أراد أن يخرج بالبلاد من حال الشلل التي أصابتها، بينما أصرت أحزاب المعارضة على موقفها وأرادت إبقاء الحصان خلف العربة.
حكم قيس سعيد تونس مفوّضا من الشعب، وباسم الشعب، الذي ملّ إطلاق الشعارات باسم الخوف على الديمقراطية.
شبعنا شعارات وشبعنا أيديولوجيا، تونس ليست مختبر تجارب ليتناوب عليها رؤساء الحكومات، بينما الرئيس منزوع الصلاحيات.
هذه هي رسالة التونسيين للأحزاب السياسية، التي عجزت عن تلقفها منذ اللحظة الأولى، فراحت تندب الديمقراطية والحريات الفردية.
بالطبع، هذا لا ينفي تماما أن أحزاب المعارضة اقترحت من حين إلى آخر خطوات لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ولكنها اقتراحات تبقى في نطاق العموميات، دون أن تقدم تفاصيل لكيفية تنفيذ هذه المقترحات أو تقدم خطة زمنية لتنفيذها، والأهم هي لم تقل للتونسيين من أين سيأتي التمويل.
سهل أن يقال سنعمل على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحفيز الاستثمار، وإصلاح النظام الضريبي، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وإنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي.. إلى آخره من الوعود الطيبة.
ولكن، دون تقديم برامج مفصلة تشرح كيفية تحقيق ذلك، تبقى الوعود مجرد نوايا طيبة. ولا داعي هنا للتذكير بأن “جهنم مبلطة بالنوايا الطيبة”.
خمس سنوات في الحكم شهد خلالها العالم أزمات خانقة، تعتبر إنجازا يستحق الإشادة.. هناك وعي تونسي بما يجري في العالم. التونسيون يعلمون أن الاقتصاد وحده هو ما سيحسم نتيجة الانتخابات.
في ظل ضبابية الانتقادات وعدم وجود برنامج اقتصادي واضح تتفق عليه المعارضة، تبدو نتائج الانتخابات محسومة.