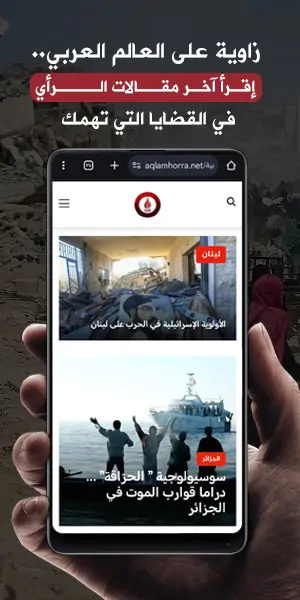في الوقت الذي يأخذ فيه السؤال عن ماهيّة ردّ طهران المفترض على استهداف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من شهر نيسان الجاري حيّزاً كبيراً لدى وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وألوانها، يجنح كثير من الساسة والمتابعين إلى تفسير صمت نظام الأسد حيال الحرب على غزة وانضباطه الكامل بما يسمى قواعد الاشتباك مع الكيان الصهيوني، على أنّه إرهاصات عملية نحو انتهاج سياسة الابتعاد التدريجي عن إيران.
ويعزّز هؤلاء زعمهم بما يشاع عن خروقات أمنية بالغة الدقّة والأهمية أتاحت لإسرائيل تحديد هدفها بدقة عالية، ما يعني أن تلك الخروقات المزعومة لا يمكن أن تحصل إلّا من جهات أمنية رفيعة المستوى وليست بعيدة عن الدائرة الأمنية الضيّقة المحيطة برأس النظام في دمشق.
قبل نفي أو تأكيد هذا الزعم تنبغي الإشارة إلى أن الرهان على انفكاك نظام الأسد عن إيران لم يكن وليد الظرف الراهن، بل هو رهان عربي قديم يعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، إذ تمكّن حافظ الأسد طوال سنوات الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) من إيهام دول الخليج بأنه صمّام الأمان الذي يحول دون استهداف الخميني لأمن الخليج العربي، كما تمكّن من إيهام كثيرين بأن نظامه يجسّد عماد التوازن الرادع لأي انفلات أمني يمكن أن تفضي إليه مواجهة عربية إيرانية في المنطقة، تلك كانت استراتيجية الأسد الأب التي ضمنت له ديمومة الابتزاز المالي الموازي لمنطق الاستعلاء والصلف الذي اتسم به خطابه السياسي المناور ونهجه البراغماتي المُستمَد من منطق الممانعة والمقاومة الافتراضية التي ما تزال تنطلي على جمهور كبير من العرب.
وقد كان لتوقف الحرب بين طهران وبغداد – آنذاك – نتائج كارثية من الجانب الاقتصادي على نظام دمشق، إذ توقّف شريان الابتزاز المالي الذي كان يعتاش عليه حافظ الأسد من دول الخليج، ومرت سوريا بسنوات عجاف نتيجة الشح الاقتصادي الذي تزامن مع حصار أميركي أوروبي أدّى إلى فقدان معظم الحاجيات المعيشية للمواطن السوري، إلى أن جاءت حرب الكويت (1990 – 1991) وأعادت لنظام الأسد فرصة الانتعاش من جديد عبرَ انخراطه بالتحالف الدولي في حربه على العراق.
يمكن التأكيد على أن هواجس العرب من الخطر الإيراني ما تزال قائمة طالما أن استراتيجية إيران التي أسسها الخميني ما تزال قائمة هي الأخرى، إلّا أن تلك المخاوف ربما يرتفع منسوبها أو ينخفض وفقاً لسياسات الدول الكبرى حيال إيران، وتحديداً السياسة الأميركية التي شهدت في عهد الحزب الديمقراطي عبر حكومتي ( أوباما وبايدن) انفتاحاً صريحاً ومهادنة لا لبس فيها حيال طهران، وبات الخطاب الأميركي يوحي بوضوح نحو المضي في احتواء خطر إيران عبر الإقرار بمصالحها في المنطقة والتفاهم معها بدلاً من التصادم أو الإجهاز عليها، الأمر الذي أجّج من جديد مخاوف دول الخليج من سطوة المدّ الإيراني وتداعياته على أمن تلك الدول واستقرارها، وهكذا عاد من جديد استحضار فكرة (الوسيط أو صمّام الأمان المزعوم) إلى الأذهان، وقد بدأت الترجمة العملية لتلك الفكرة بإعادة البحرين والإمارات فتح سفارتيهما في دمشق أواخر العام 2018، وفي العام 2021 أقدم الأردن على إعادة علاقاته مع نظام دمشق، بعد زيارات متبادلة لبعض وزارتي البلدين، ثم تبنّى مشروع ما سُمّي (خطوة مقابل خطوة) الذي لاقى دعماً روسياً وخليجياً وأميركياً بآن معاً، في مسعى يهدف إلى تعويم الأسد ودمجه في المحيط العربي.
ثم تكللت تلك المساعي بعودة العلاقات السعودية مع دمشق موازاة مع إعادة الأسد إلى الجامعة العربية وحضوره قمة جدة في شهر أيار/مايو من العام الماضي. ولعل ما لا يمكن نكرانه أن الانعطافة العربية تجاه الأسد جسّدت قناعة معظم الدول العربية بأن بشار الأسد ليس المقصود بذاته، بل يمكن أن يكون بوابة لاسترضاء إيران، وبهذا تعود استراتيجية الأسد الأب من جديد ليستثمرها الابن، ولكن في ظروف مختلفة جذرياً عما كان عليه الأمر من قبل، سواءٌ بالنسبة إلى سوريا أو الدول العربية الأخرى.
على أي حال، ثمة جملة من المعطيات ربما تكون موجعة للعرب، ولدول الخليج والأردن على وجه التحديد، ولهذا يمكن التأكيد على أن جميع الذين يبدون التوسّم خيراً بالأسد، دواخلهم تضمر خلاف ذلك، ولكن ما الذي يجبرهم على “تجريب المُجرّب” كما يقال؟ أهو الجهل بطوّية نظام دمشق؟ بالتأكيد ليس الأمر كذلك، ولا صلة لهذا الأمر أيضاً بأي جانب مصلحي ذي صلة بالتنمية أو الاقتصاد أو أي مصلحة مجتمعية أخرى، بل يمكن التأكيد على أنها المصلحة الأمنية أولاً، وأمن أنظمة الحكم على وجه التحديد، إذ إن هذا الجانب هو البوصلة التي توجّه سياسات معظم الأنظمة العربية، بعيداً عن أي مصالح أو مواقف أو مبادئ حتى ولو طالت مصائر شعوبها. لعل العصا الإيرانية ما تزال الكابوس الذي يقض مضاجع معظم دول المنطقة، وطالما استمر الرادع الأميركي في مهادنة تلك العصا ومغازلتها فلا غرابة أن يكون الأسد محطة عبور نحو التماس الأمان وفقاً للمثل للقائل: “كلب الأمير أمير”.
ثمة أمور ثلاثة لا ينبغي أن تغيب عن ذي لب، يحيل الأول إلى أن عضوية العلاقة بين دمشق وطهران لم يعد الأسد فاعلاً بالتحكّم بسيرورتها، أعني أن إيران تجاوزت مرحلة الشريك للأسد في حكم سوريا وباتت بمنزلة الوصيّ عليه، وبهذا لم يعد الظن بقدرة الأسد على الابتعاد أو الاقتراب في العلاقة قائماً. ويحيل الأمر الثاني إلى أن انضباط الأسد والتزامه بالصمت حيال ما يجري في غزة ليس أمراً جديداً، وهل استطاعت قوات الأسد الردّ ولو لمرة واحدة على القصف الإسرائيلي المتكرر منذ سنوات داخل الجغرافيا السورية؟ ألا يعلم رأس النظام قبل سواه أنه مدين لإسرائيل في بقائه بالسلطة بعد كل هذا الخراب؟ وهل سمحت السلطات السورية لمظاهرة واحدة مناصرة لغزة في أيٍّ من مناطق سيطرتها؟ أما الأمر الثالث فيؤكّد أن إيران ليست محتاجة للأسد عسكرياً، ولا تريد من الأسد أن يبادر بأي مشاغبة حيال إسرائيل، ما تريده إيران هو الجغرافيا السورية، تماما كما لبنان والعراق واليمن، تريد دولاً تجعل منها مسارح لمعارك خارج حدودها بالوكالة، ولتبق هذه الدول مرتعاً للخراب والموت والدمار، وبهذا ستبقى سوريا مجالاً حيوياً لإيران طالما استمر الأسد في السلطة، والاعتقاد بتجريف نفوذ إيران من البلاد السورية مع استمرار السلطة الحالية هو ضرب من الوهم.